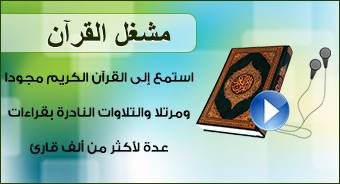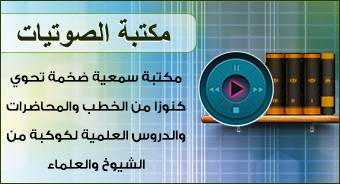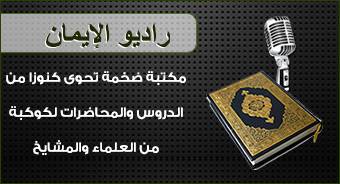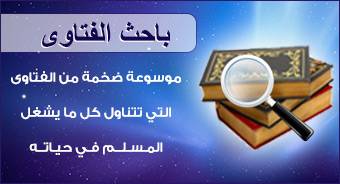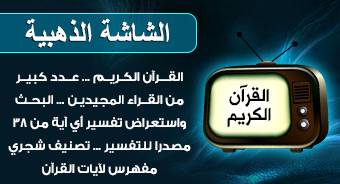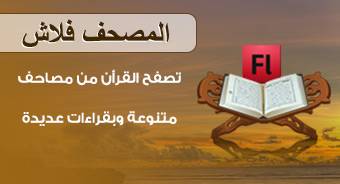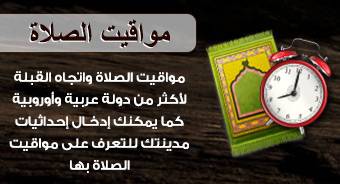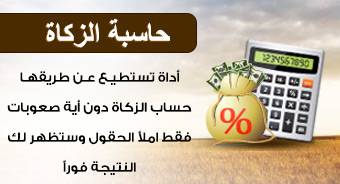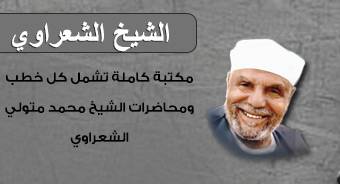|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صبح الأعشى في كتابة الإنشا (نسخة منقحة)
وقد عأبوا أخذ المعنى إذا كان ظاهراً مكشوفاً، فما ظنك بمن يأخذ الكلام برمته واللفظ بصورته، فيصير ناسخاً لكلام غيره، وناقلاً له! فأي فضيلة في ذلك؟ وقد قيل: من أخذ معنى بلفظه كان سارقاً، ومن أخذ بعض لفظه كان سالخاً، ومن أخذه فكساه لفظاً من عنده كان أولى به ممن تقدمه، وأين من هو أولى بالشيء ممن سبقه إليه ممن يعد سارقاً وسالخاً؟ ويقال إن أبا عذرة الكلام من سبك لفظه على معناه، ومن أخذ معنى بلفظه فليس له فيه نصيب. هذا فيمن أخذ سجعة أو سجعتين في خطبة أو رسالة، أو بيتاً أو بيتين في قصيدة وما قارب ذلك؛ أما من أخذ القصيدة بكمالها، أو الخطبة أو الرسالة برمتها، أو لفقها من خطب أو رسائل فذاك إنما يعد ناسخاً إن أحسن النقل، أو ماسخاً إن أفسده.واعلم أن الناثر الماهر، والشاعر المفلق قد يأتي بكلام سبقه إليه غيره، فيأتي بالبيت من الشعر، أو القرينة من النثر، أو أكثر من ذلك بلفظ الأول من غير زيادة ولا نقصان، أو بتغيير لفظ يسير، وهذا هو الذي يسميه أهل هذه الصناعة وقوع الحافر على الحافر. وقد سئل أبو عمرو بن العلاء عن الشاعرين يتفقان على لفظ واحد ومعنى فقال: عقول رجال توافت على ألسنتها.والواقع من ذلك في كلامهم على قسمين:القسم الأول ما وقع الاتفاق فيه في المعنى واللفظ جميعاً.كقول الفرزدق: ووافقه جرير فقال مثل ذلك من غير زيادة ولا نقص.ويروى أن عمر بن أبي ربيعة أنشد ابن عباس رضي الله عنه: فقال ابن عباس رضي الله عنه: فقال عمر: والله ما قلت إلا كذلك.قال أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين: وأنشدت الصاحب إسماعيل بن عباد رحمه الله: فسبقني وقال: وكذلك كنت قلت: قال الوزير ضياء الدين بن الأثير رحمه الله في كتابه المثل السائر: ويحكى أن امرأة من عقيل يقال لها ليلى كان يتحدث إليها الشباب، فدخل الفرزدق إليها وجعل يحادثها، وأقبل فتى من قومها كانت تألفه فدخل إليها فأقبلت عليه وتركت الفرزدق، فغاظه ذلك فقال للفتى: أتصارعني؟ فقال: ذاك إليك، فقام إليه فلم يلبث أن أخذ الفرزدق فصرعه وجلس على صدره فضرط، فوثب الفتى عنه وقال: يا أبا فراس هذا مقام العائذ بك، والله ما أردت ما جرى، قال: ويحك! والله ما بي أنك صرعتني ولكن كأني بابن الأتان، يعني جريراً وقد بلغه خبري فقال يهجوني: فما مضى إلا أيام حتى بلغ جريراً الخبر، فقال فيه هذين البيتين. قال: وهذا من أغرب ما يكون في هذا الموضع وأعجبه؛ قال في الصناعتين: وإذا كان القوم في قبيلة واحدة، في أرض واحدة، فإن خواطرهم تقع متقاربة، كما أن أخلاقهم وشمائلهم تكون متضارعة. قال في المثل السائر: ويقال إن الفرزدق وجريراً كانا ينطقان في بعض الأحوال عن ضمير واحد. قال: وهذا عندي مستبعد، فإن ظاهر الأمر يدل على خلافه، والباطن لا يعلمه إلا الله تعالى، وإلا فإذا رأينا شاعراً متقدم الزمان قد قال قولاً ثم سمعناه من شاعر أتى من بعده، علمنا بشهادة الحال أنه أخذه منه؛ وهب أن الخواطر تتفق في استخراج المعاني الظاهرة المتداولة، فكيف تتفق الألسنة أيضاً في صوغ الألفاظ؟ وكلام العسكري في الصناعتين يوافقه بالعتب على المتأخر، وإن ادعى أنه لم يسمع كلام الأول في مثل ذلك.القسم الثاني ما وقع الاتفاق فيه في المعنى وبعض اللفظ وهو على ضربين:الضرب الأول ما اتفق فيه المعنى وأكثر اللفظ كقول امرئ القيس: وقول طرفة: فالتخالف بينهما في كلمة القافية فقط.وقول البعيث: وقول الفرزدق: فالتخالف بينهما في موضعين من البيت، كلمة القافية واسم القبيلة.وقول بعض المتقدمين يمدح معبداً صاحب الغناء: وقول الفرزدق بعده: فاتفقا في النصف الثاني واختلفا في النصف الأول، إلى غير ذلك من الأشعار التي وقعت خواطر الشعراء عليها، وتوافقت عقولهم عندها.الضرب الثاني ما اتفق فيه المعنى مع يسير اللفظ:فمن ذلك قول البحتري في وصف غلام: أخذه من قول أبي نواس: وقول أبي تمام: أخذه من قول حسان بن ثابت يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وقول أبي الطيب: أخذه من قول بشار: الصنف الثاني التقليد في المعاني وهذا مما لا يستغني عنه ناظم ولا ناثر:قال أبو هلال العسكري رحمه الله في كتابه الصناعتين: ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تنأول المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم، ولكن عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظاً من عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير جليتها الأولى، ويزيدوا عليها في حسن تأليفها وجودة تركيبها، وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أولى بها ممن سبق إليها. قال: ولولا أن القائل يؤدي ما سمع لما كان في طاقته أن يقول، وإنما ينطق الطفل بعد استماعه من البالغين؛ وقد قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: لولا أن الكلام يعاد لنفذ. ومن كلام بعضهم: كل شيء إذا ثنيته قصر إلا الكلام، فإنك إذ ثنيته طال، والمعاني مشتركة بين العقلاء، فربما وقع المعنى الجيد للسوقي والنبطي والزنجي. وإنما يتفاضل الناس في الألفاظ ورصفها، وتأليفها ونظمها، وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون على تداول المعاني بينهم، فليس على أحد فيه عيب إلا إذا أخذه بكل لفظه، أو أفسده في الأخذ وقصر فيه عمن تقدمه. قال في الصناعتين: وما يعرف للمتقدم معنى شريف إلا نازعه فيه المتأخر وطلب الشركة فيه معه، إلا بيت عنترة: فإنه ما نوزع فيه على جودته. قال: وقد رامه بعض المحدثين فاتضح مع العلم بأن ابتكار المعنى والسبق إليه ليس فيه فضيلة ترجع إلى المعنى، وإنما ترجع الفضيلة فيه إلى ابتكره وسبق إليه؛ فالمعنى الجيد جيد وإن كان مسبوقاً إليه، والوسط وسط والرديء رديء، وإن لم يكن مسبوقاً إليهما. على أن بعض علماء الأدب قد ذهب إلى أنه ليس لأحد من المتأخرين معنى مبتدع، محتجاً لذلك بأن قول الشعر قديم مذ نطق باللغة العربية، وأنه لم يبق معنى من المعاني إلا وقد طرق مراراً. قال في المثل السائر: والصحيح أن باب الابتداع مفتوح إلى يوم القيامة، ومن الذي يحجر على الخواطر وهي قاذفة بما لا نهاية له؟ إلا أن من المعاني ما يتساوى فيه الشعراء ولا يطلق عليه اسم الابتداع لأول قبل آخر لأن الخواطر تأتي به من غير حاجة إلى اتباع الآخر الأول، كقولهم في الغزل: وقولهم في المديح: إن عطاءه كالبحر أو كالسحاب، وإنه لا يمنع عطاء اليوم عطاء غد، وإنه يجود بماله من غير مسألة؛ وأشباه ذلك.وقولهم في المراثي: إن هذا الرزء أول حادث، وإنه استوى فيه الأباعد والأقارب، وإن الذاهب لم يكن واحداً وإنما كان قبيلة، وإن بعد هذا الذاهب لا يعد للمنية ذنب، وما أشبه ذلك. وكذلك سائر المعاني الظاهرة التي تتوارد عليها الخواطر من غير كلفة، ويستوي في إيرادها كل بارع. قال: ومثل ذلك لا يطلق على الآخر فيه اسم السرقة من الأول، وإنما يطلق اسم السرقة في معنى مخصوص كقول أبي تمام: فإن هذا معنى ابتداعه مخصوص بأبي تمام، وذلك أنه لما أنشد أحمد بن المعتصم قصيدته السنيية التي مطلعها: انتهى إلى قوله منها: فقال الحكيم الكندي: وأي فخر في تشبيه ابن أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق أبو تمام ثم أنشد هذين البيتين معتذراً عن تشبيهه إياه بعمرو وحاتم وإياس. فالحال يشهد بابتداعه هذا المعنى، فمن أتى بعده بهذا المعنى أو بجزء منه كان سارقاً له، وكذلك كل ما جرى هذا المجرى. ولم يزل الشعراء والخطباء يقتبسون من معاني من قبلهم، ويبنون على بناء من تقدمهم.فمما وقع للشعراء من ذلك قول أبي تمام: أخذه من قول عبد الله بن الزبير لما قتل مصعب بن الزبير: ونما التسليم والسلو لحزماء الرجال، وإن الجزع والهلع لربات الحجال؛ وقوله أيضاً: أخذه من قول زياد ابن أبيه لأبي الأسود الدؤلي: لولا أنك ضعيف لاستعملتك، وقول أبي الأسود له في جواب ذلك: إن كنت تريدني للصراع فإني لا أصلح له، وإلا فغير شديد أن آمر وأنهى، وقوله من قصيدة البيت المتقدم: أخذه من قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: وقول أبي الطيب المتنبي: أخذه من قول أرسطوطاليس: إذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة.وقول الخاسر: أخذه من قول بشار: فلما سع بشار بيت الخاسر قال: ذهب ابن الفاعلة ببيتي. ومثل هذا وأشباهه مما لا ينحصر كثرة، ولا يكاد أن يخلو عنه بيت إلا نادراً.ومما وقع للكتاب من ذلك ما كتب به إبراهيم بن العباس من قوله في فضل من كتاب: إذا كان للمحسن من الثواب ما يقنعه، وللمسيء من العقاب ما يقمعه، أزداد المحسن في الإحسان رغبة، وانقاد المسيء للحق رهبة. أخذه من قول علي كرم الله وجهه: يجب على الوالي أن يتعهد أموره، ويتفقد أعوانه، حتى لا يخفى عليه إحسان محسن، ولا إساءة مسيء، ثم لا يترك واحداً منها بغير جزاء؛ فإن ترك ذلك تهاون المحسن واجترأ المسيء، وفسد الأمر، وضاع العمل.وما كتب به بعض الكتاب في فصل وهو: لو سكت لساني عن شكرك، لنطق أثرك علي. وفي فصل آخر: ولو جحدتك إحسانك لأكذبتني آثارك، ونمت علي شواهدها؛ أخذه من قول نصيب: وما كتب به أحمد بن يوسف من فصل وهو: أحق من أثبت لك العذر في حال شغلك، من لم يخل ساعة من برك في وقت فراغك. أخذه ن قول عي رضي الله عنه: لا تكونن كمن يعجز عن شكر ما أولي، ويلتمس الزيادة فيما بقي.والاقتباس من الأحاديث والآثار كثير، وقد تقدم الكلام عليه قبل ذلك. قال في الصناعتين: ومن أخفى أسباب السرقة أن يأخذ معنى من نظم فيورده في نثر، أو من ثر فيورده في نظم، أو ينقل المعنى المستعمل في صفة خمر فيجعله في مديح، أو في مديح فينقله إلى وصف، إلا أنه لا يصل لهذا إلا المبرز الكامل المقدم.وقال في المثل السائر: أشكل سرقات المعاني، وأدقها وأغربها، وأبعدها مذهباً، أن يؤخذ المعنى مجرداً من اللفظ. قال: وذلك مما يصعب جداً ولا يكاد يأتي إلا قليلاً، ولا يتفطن له ويستخرجه من الأشعار إلا بعض الخواطر دون بعض.فمن ذلك قول أبي تمام في المدح: أخذه من قول عروة بن الورد من شعراء الحماسة: فعروة جعل اجتهاده في طلب الرزق عذراً يقوم مقام النجاح، وأبو تمام جعل الموت في الحرب الذي هو غاية اجتهاد المجتهد في لقاء العدو قائماً مقام الانتصار؛ قال في المثل السائر: وكلا المعنيين واحد، غير أن اللفظ مختلف. وأظهر من ذلك أخذاُ قول القائل: أخذه من قول ابن المقفع في باب المراثي من الحماسة: على أنه ربما وقع للمتأخر معنى سبقه إليه من تقدمه من غير أن يلم به المتأخر ولم يسمعه؛ ولا استبعاد في ذلك كما يستبعد اتفاق اللفظ والمعنى جميعاً. قال أبو هلال العسكري: وهذا أمر قد عرفته من نفسي فلا أمتري فيه، وذلك أني كنت عملت شيئاً في صفة النساء فقلت: وظننت أني لم أسبق إلى جمع هذين التشبيهين حتى وجدت ذلك بعينه لبعض البغداديين فكثر تعجبي، وعزمت على ألا أحكم على المتأخر بالسرقة من المتقدم حكماً حتماً.إذا تقرر ذلك فسرقة المعنى المجرد عن اللفظ لا تخرج عن اثني عشر ضرباً.الضرب الأول: أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه ولا يكون هو إياه:قال في المثل السائر: وهذا من أدق السرقات مذهباً وأحسنها صورة، ولا يأتي إلا قليلاً. فمن ذلك قول المتنبي: وهذا المعنى استخرجه المتنبي من قول بعض شعراء الحماسة، وإن لم يكن صريحاً فيه حيث يقول: قال في المثل السائر: والمعرفة بأن هذا المعنى من ذلك المعنى عبر غامض غير متبين إلا لمن أعرق في ممارسة الشعر، وغاص على استخراج المعاني. قال: وبيان ذلك أن الأول يقول: إن بغض الذي هو غير طائل أياي قد زاد نفسي حباً إلي، أي قد جملها في عيني وحسنها عندي كون الذي هو غير طائل منقصي؛ والمتنبي يقول: إن ذم الناقص إياه بفضله كتحسين بغض الذي هو غير طائل نفس ذلك عنده.وأظهر من ذلك أخذاً من هذا الضرب قول البحتري في قصيدة يفخر فيها بقومه: أخذه من قول أبي تمام في وصف جمل: فأبو تمام ذكر أن الجمل رعى الأرض، ثم سار فيها فرعته أي أهزلته، فكأنها فعلت به مثل ما فعل بها؛ والبحتري نقله إلى وصف الرجل بعلو السن والهرم، فقال: إنه كان يحمل الرمح في القتال، ثم صار يركب الرمح أي يتوكأ منه على عصا كما يفعل الشيخ الكبير.وأوضح من ذلك وأكثر بياناً في الأخذ قول البحتري أيضاً: أخذه من قول أبي تمام: الضرب الثاني: أن يؤخذ المعنى فيعكس:قال في المثل السائر: وذلك حسن يكاد يخرجه حسنه عن حد السرقة.فمن ذلك قول أبي نواس: وقول ابن الوليد في عكسه: ومنه قول ابن جعفر: وقول غيره في عكسه: أما ابن جعفر فإنه ألقى عن منكبيه رداء الغيرة؛ وأما الآخر فإنه جاء بالضد من ذلك وبالغ غاية المبالغة، ومنه قول أبي الشيص: وقول أبي الطيب في عكسه: ومنه قول أبي تمام: وقول الوزير ضياء الدين بن الأثير في عكسه: الضرب الثالث: أن يؤخذ بعض المعنى دون بعض:فمن ذلك قول أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: وقول أبي تمام بعده: فأمية بن أبي الصلت أتى بمعنيين أحدهما أن عطاءك زين، والآخر أن عطاء غيرك ليس بزين، وأبو تمام أتى بالمعنى الأول فقط.ومنه قول علي بن جبلة: وقول أبي الطيب بعده: فابن جبلة أتى بمعنيين، أحدهما أنه فعل ما لم يفعله أحد ممن تقدمه، وإن نال الآخر شيئاً فهو مقتد به وتابع له؛ وأبو الطيب أتى بالمعنى الأول فقط، وهو أنه فعل ما لم يفعله غيره مشيراً إلى ذلك بقوله: أي يستبكرها ويزيل عذرتها.ومنه قول الآخر: وقول البحتري بعده: فالبحتري اقتصر على بعض المعنى ولم يستوفه.الضرب الرابع: أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى آخر:قال في المثل السائر: وهذا النوع من السرقات قليل الوقوع بالنسبة إلى غيره.فمن ذلك قول الأخنس بن شهاب: وقول مسلم بن الوليد بعده: أخذ مسلم المعنى الذي أورده الأخنس وهو وصل السلاح إذا قصر بالخطايا إلى العدو وزاد عليه عدم تعريدهم أي قرارهم إذا عرد السيف. ومنه قول جرير في وصف أبيات من شعره: وقول أبي تمام بعده: فزاد أبو تمام على جرير قران ذلك بالممدوح ومدحه مع الأبيات. ومنه قول المعذل بن غيلان: وقول أبي تمام بعده: فزاد عليه قوله: ومما اتفق لي نظمه في هذا الباب أنه لما عمرت مدرسة الظاهر برقوق بين القصرين بالقاهرة المحروسة، وكان القائم بعمارتها الأمير جركس الخليلي أمير اخور الظاهري، وكان قد اعتمد بناءها بالصخور العظيمة التي لا تقلها الجمال حملاً، ولا تحمل إلا على العجل الخشب، فأولع الشعراء بالنظم في هذا المعنى؛ فنظم بعض الشعراء أبياتاً عرض فيها بذكر الخليلي وقيامه في عمارتها، ثم قال في آخرها: وألزمني بعض الإخوان بنظم شيء في المعنى، فوقع لي أبيات من جملتها: فزدت عليه ذكر الوحا الذي معناه السرعة أيضاً وصار مطابقاً لما يأتي به المعزمون في عزائمهم من قولهم: الوحا الوحا العجل العجل مع ما تقدم له من التوطئة بقولي: تخال الجن تنقلها. على أني لست من فرسان هذا الميدان، ولا من رجال هذا الوغى.الضرب الخامس: أن يؤخذ المعنى فيكسى عبارة أحسن من العبارة الأولى:قال في المثل السائر: وهذا هو المحمود الذي يخرج به حسنه عن باب السرقة؛ فمن ذلك قول أبي تمام: أخذه البحتري فقال: ومنه قول أبي نواس: وقول أبي الطيب بعده: ومنه قول أبي العلاء بن سليمان في مرثية: وقول القيسراني بعده: ومنه قول ابن الرومي: وقول من بعده: الضرب السادس: أن يؤخذ المعنى ويسبك سبكاً موجزاً:قال في المثل السائر: وهو من أحسن السرقات: لما فيه من الدلالة على بسطة الناظم في القول وسعة باعه في البلاغة، فمن ذلك قول أبي تمام: وقول ابن الرومي بعده: فأخذ معنى البيتين في بيت واحد، ومنه قول أبي العتاهية: أخذه أبو تمام فقال: فأوجز في هذا المعنى غاية الإيجاز؛ ومنه قول أبي تمام يمدح أحمد بن سعيد: أخذه أبو الطيب فأوجز في أخذه فقال: ومن قول بعض الشعراء: أخذه أبو الطيب فقال: الضرب السابع: زيادة البيان مع المساواة في المعنى بأن يؤخذ المعنى فيضرب له مثال يوضحه:فمن ذلك قول أبي تمام: أخذه أبو الطيب فقال: فزاده وضوحاً بضرب المثال له بالجهام وهو السحاب الذي لا مطر فيه.ومنه قول أبي تمام أيضاً: أخذه أبو الطيب فقال: فضرب له مثالاً بظهور أنياب الليث فزاده وضوحاً.ومنه قول أبي تمام أيضاً: أخذه البحتري فقال: فضرب له مثلاً بالكواكب في ظلام الليل فأوضحه وزاده حسناً.الضرب الثامن: اتحاد الطريق واختلاف المقصود:مثل أن يسلك الشاعران طريقاً واحدة فتخرج بهما إلى موردين، وهناك يتبين فضل أحدهما على الآخر.فمن ذلك قول النابغة: وهذا المعنى قد توارده الشعراء قديماً وحديثاً وأوردوه بضروب من العبارات، فقال أبو نواس: وقال مسلم بن الوليد: وقال أبو تمام: وكل هؤلاء قد أتوا بمعنى واحد لا تفاضل بينهم فيه إلا من جهة حسن السبك أو من جهة الإيجاز. قال: ولم أر أحداً أغرب في هذا المعنى فسلك هذا الطريق مع اختلاف مقصده إلا مسلم بن الوليد فقال: فهذا قد فضل به مسلم غيره في هذا المعنى، ولما انتهى الأمر إلى أبي الطيب سلك هذه الطريق التي سلكها من تقدمه، إلا أنه خرج فيها إلى غير المقصد الذي قصدوه فأغرب وأبدع، وحاز الإحسان بجملته، وصار كأنه مبتدع لهذا المعنى دون غيره فقال: فحوى طرفي الإغراب والإعجاب.الضرب التاسع: بياض بالأصل.الضرب العاشر: أن يكون المعنى عاماً فيجعل خاصاً أو خاصا فيجعل عاماً:وهو من السرقات التي يسامح صاحبها؛ فأما جعل العام خاصاً فمن ذلك قول الأخطل: أخذه أبو تمام فقال: فالأخطل نهى عن الإتيان بما ينهى عنه مطلقاً فجاء بالخلق منكراً فجعله شائعاً في بابه، وأبو تمام خصص ذلك بالبخل وهو خلق واحد من جملة الأخلاق.وأما جعل الخاص عاماً، فمن ذلك قول أبي تمام: أخذه أبو الطيب فجعله عاماً فقال: الضرب الحادي عشر: قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة:قال في المثل السائر: وهذا لا يسمى سرقة بل يسمى إصلاحاً وتهذيباً، فمن ذلك قول أبي نواس في أرجوزة يصف فيها اللعب بالكرة والصولجان فقال من جملتها: أخذه المتنبي فقال: فهذا في غاية العلو والارتقاء بالنسبة إلى قول أبي نواس، ومنه قول أبي الطيب: وقول ابن نباتة السعدي: فكلام ابن نباتة أحسن في الصورة من كلام المتنبي هنا وإن كان مأخوذاً منه.الضرب الثاني عشر: قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة:وهو الذي يعبر عنه أهل هذه الصناعة بالمسخ، وهو من أرذل السرقات وأقبحها، فمن ذلك قول أبي تمام: أخذه أبو الطيب فمسخه فقال: ومنه قول عبد السلام بن رغبان: أخذه أبو الطيب فمسخه فقال من أبيات: المسلك الثاني طريقة الاختراع:قال الوزير ضياء الدين بن الأثير في المثل السائر: فهي ألا يتصفح كتابة المتقدمين ولا يطلع على شيء منها، بل يصرف همته إلى حفظ القرآن الكريم وكثير منن الأخبار النبوية وعدة من دواوين فحول الشعراء ممن غلب على شعره الإجادة في المعاني والألفاظ، ثم يأخذ في الاقتباس من القرآن والأخبار النبوية والأشعار فيقوم ويقع، ويخطئ ويصيب، ويضل ويهتدي، حتى يستقيم إلى طريق يفتتحها لنفسه؛ وأخلق بتلك الطريق أن تكون مبتدعة غريبة لا شركة لأحد من المتقدمين فيها! قال: وهذه الطريق هي طريق الاجتهاد وصاحبها يعد إماماً في الكتابة كما يعد الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من المجتهدين في علم الفقه، إلا أنها مستوعرة جداً، لا يستطيعها إلا من رزقه الله تعالى لساناً هجاماً، وخاطراً رقاماً. قال: ولا أريد بهذا الطريق أن يكون الكاتب مرتبطاً في كتابته بما يستخرجه من القرآن الكريم والأخبار النبوية والأشعار، بحيث أنه لا ينشئ كتاباً والأشعار، ثم نقب عن ذلك تنقيب مطلع على معانيه، مفتش على دفائنه، وقلبه ظهراً لبطن، عرف حينئذ من أين تؤكل الكتف فيما ينشئه من ذات نفسه، واستعان بالمحفوظ على الغريزة الطبيعية. على أنه لا بد للكاتب المرتقي إلى درجة الاجتهاد في الكتابة مع حفظ القرآن الكريم، والاستكثار من حفظ الأخبار النبوية، والأشعار المختارة، من العلم بأدوات الكتابة وآلات البيان: من علم اللغة، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، ليتمكن من التصرف في اقتباس المعاني واستخراجها فيرقى إلى درجة الاجتهاد في الكتابة؛ كما أن المجتهد م الفقهاء إذا عرف أدوات الاجتهاد: من آيات الأحكام، وأحاديثها، ونعتها، وعرف النحو والناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، والحساب والفرائض وإجماع الصحابة، وغير ذلك من آلات الاجتهاد وأدواته، استخرج بفكره حينئذ ما يؤديه إليه اجتهاده؛ فالمجتهد في الكتابة يستخرج المعاني من مظانها من القرآن الكريم، والأخبار النبوية، والأشعار، والأمثال، وغير ذلك بواسطة آلة الاجتهاد، كما أن المجتهد في الفقهيات يستخرج الأحكام من نصوص الكتاب والسنة بواسطة آلة الاجتهاد. فإذا أراد الكاتب المتصف بصفة الاجتهاد في الكتابة إنشاء خطبة أو رسالة أو غيرها مما يتعلق بفن الإنشاء.بياض في الأصل.
|